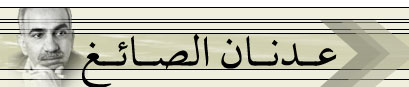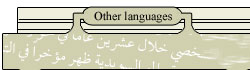|
تأبَّطَ منفَى.. وهموماً أُخرى
دراسة في شِـعر عدنان الصائغ
الدكتور مقداد رحيم
يبدو عدنان الصائغ في مجموعته الشعرية الجديدة "تأبط مَنـفَى" أكثراً يُسراً ووضوحاً منه في شعره السابق، وأخصُّ تحديداً "نشيد أوروك" الذي نشر في العام 1996. فالشاعر هنا يكتب وهو محاط بشيءٍ من الطمأنينة والاستقرار في منفاه، يكتب بإرادته الواعية، وهو هناك محبوس في ظلمةٍ من التشرد والخوف والقلق فكان شعره كابوساً طويل الأمد تتخلله يقظات خفيفة، يكتب ولا يدري إلى أين يكون المآل.
وعلى الرغم من هذا الاستقرار فإنَّ الشرَّ ما زال يلاحقه ويلازمه بوصفه منفىً، فأيّ استقرارٍ يكون بلا وطن؟، وهذه هي دلالة العنوان الذي جعله لمجموعته الشعرية هذه، وفيه يستبدل بذكاءٍ كلمة "شراً" بكلمة "منفى"، ثم تخرج المجموعة من دار المنفَى للطبع والنشر في السويد حيث يقيم الشاعر. وهو إذ يستخدم كلمة المنفى وليس المهجر فإنما ليعبر
عن حالةٍ تزولُ يوماً ما، فالمنفى مسكن مؤقت يعود بعده المرءُ لوطنه الأول، والمهجر سلوانٌ للوطن.
وعندما أَسِمُ شعره في هذه المجموعة بأنه أكثر وضوحاً وأيسر للقارئ فإنني لا أنفي الوضوح عن شعره جميعاً على الإطلاق، فعدنان الصائغ يكتب قصيدته بوضوحٍ يجعل منه في منأى عن كثير من الشعراء المحدثين الذي يكتبون على طريقة "عضَّ كلبٌ شاردٌ رِجْلَ القمر"!، وينحتون في اللغة نحتاً غريباً ويظنون أن ذلك هو غاية الشعر الحديث ومهمته، غير مبالين بضرورة وجهته إلى الجمهور لا إلى الصفوة، أو إلى الذات. غير أنَّ إغماءاتهِِ التي سجلها في هذه المجموعة لمْ يعترضها من الكوابيس إلاَّ نزرٌ قليل.
إن عدنان الصائغ من البقية الباقية من الشعراء الذي يكتبون بالسليقة، إلى الحد الذي تتعسر فيه جملتُهُ الشعرية أحياناً، فتشذ عن الإعراب، وتنفر عن قطيع القواعد المعهودة، ولكنه في الآخر يعرف ماذا يريد أن يقول لزائر شعره، دون أنْ يُخاتلَهُ، أو أنْ يُجادله، ودون أن يُعاضل في الكلام، أو يفتعلَ موضوعه الشعري. ولذلك فإن الناظر في شعره يعرف مسارب قصائده وغاياتها، كما يهتدي بسهولةٍ ويُسر إلى مواطن الفنِّ فيها، وفي الوقت نفسه لا يصعب عليه وضع اليد على مواطن الخلل.
وقارئ "تأبط منفى" يعرف منذ القصيدة الأولى أن عدنان الصائغ مسكون بالشعر، مُـتَّحدٌ وإياه اتحاداً قدرياً، ويوظفه بوصفه معادلاً موضوعياً لشخصه هو:
"نسيتُ نفسي على طاولة مكتبتي
ومضيتُ
وحين فتحتُ خطوتي في الطريق
اكتشفتُ أنني لاشيءَ غير ظلٍّ لنصٍّ
أراهُ يمشي أمامي بمشقَّةٍ
ويصافح الناسَ كأنه أنا"
وفضلاً عن تعبيره هو عن هذا الاتحاد والتلازم المستمر، فإنَّ المتتبع لقصائده يجدهُ يُسجل كلَّ لحظةٍ واعيةٍ تستحق التسجيل في حياته ويُحيلها إلى اللاوعي حيث يُعالجها في معمل شعره، فتنفثُها السليقة إلى الخارج من حيث لا يدري، ولكن قارئه سوف يدري عند القراءة كلَّ تحركاته، ويُمسك بتلابيب مشاعره في تلك التحركات، حتى الصعب المعقد منها، وسوف يستطيع أن يرسم خارطةً لِخُطاه الممتدة بين مدنٍ وشوارع وساحات وممرات ومحطات ومطارات وفنادق وحانات ومقاهٍ وحدائق وأنهار وقنوات وصخور لا يربط بينها خيط مستقيم، ولا انتماء واحد، وهو في كل هذه الأمكنة وأزمنتها ذلك الشاعر الشاعر بها واعياً وغائباً عن وعيه: بغداد، الكوفة، بيروت، مالمو، بودن جنوب القطب، روتردام، دمشق، لوليو، صُور، بعلبك، مقهى على ساحل كوبنهاكن، الخرطوم، فندق كوسيا في براغ، مقهى الكوفي دو باغيه في بيروت، عمان، مقهى المودكا في بيروت، أمام سجن فردان في بيروت، مكتبة لوليو، الساحة الهاشمية في عمان، فستروس، مقهى الروضة في دمشق، مهرجان الشعر العالمي في هولندا، أم درمان، مطار كوبنهاكن، يونشوبنغ، صخرة طونيوس في بيروت، مقهى حسن عجمي، حانة في جنوب القطب، عدن،قناة دوفر، حديقة الهايدبارك في لندن، براغ، مقهى الفينيق في عمان، مهرجان جرش في عمان، صنعاء، أمستردام، أوسلو، كورنيش النيل في القاهرة، برلين، وما يُصاحبه خلال ذلك من مشاعر مختلفةٍ مختلطةٍ معذِّبة.
ولكن ما هو ذاك الصعب المعقد من مشاعره؟.
أما الصعب منها فكلُّها، إذْ يَـتَـنازعُها الخوفُ والفزعُ والجوعُ وكلُّ ما هو سلبي في الحياة:
"أقلّ قرعة بابٍ
أُخفي قصائدي –مرتبكاً- في الأدراج
لكن كثيراً ما يكون القرع
صدىً لدوريات الشرطة التي تدور في شوارع رأسي
ورغم هذا فأنا أعرف بالتأكيد
أنهم سيقرعون البابَ ذات يومٍ
وستمتدُّ أصابعهم المدربة كالكلاب البوليسية إلى جوارير قلبي
لينتزعوا أوراقي
وحياتي
ثم يرحلون بهدوء"
ففي هذه القصيدة التي كتبها في بيروت خوف شديد تبرره تجارب الشاعر السابقة في وطنه العراق حيث انعدام حرية الكلمة التي هي أداته في التعبير، وربما حَدسُهُ المجرد، لأنه كتب هذه القصيدة في منفاه، ولكن الخوف ما زال حياً نشطاً في أبجدية الشاعر، ولذلك فهو يتكرر في أساليب مختلفة في قصائد هذه المجموعة تصل إلى حد الفزع، وواحدة من تجارب الشاعر تلك قصيدته التي كتبها في بغداد، ومنها:
"أكتبُ وعنقي مشدود منذ بدء التاريخِ
إلى حبل مشنقةٍ
أكتبُ وأنا أحملُ ممحاتي دائماً
لأقلِّ طرقة بابٍ
وأضحكُ على نفسي بمرارةٍ
حين لا أجدُ أحداً
سوى الريح"
فالمشهد الذي يرسمه الشاعر يبدو واحداً مع اختلاف الزمان وتغير المكان، وهو يعرف أنه خائف حدَّ الفزع، ولكنه في الوقت نفسه يبحثُ بلا جدوى عن سبيلٍ للتخلص من هذا الفزع:
"كيفَ لي
أن أتخلَّصَ من مخاوفي
ربّاه
وعيوني مسمَّرةٌ إلى بساطيل الشرطةِ
لا إلى السماء
وبطاقتي الشخصية معي
وأنا في سرير النومِ
خشية أنْ يوقفني مخبرٌ في الأحلام"
وأما الجوع الذي يشعر به الشاعر فهو المنافس القوي لخوفه، إذْ يترددُ في مواضع عديدةٍ من قصائده:
"الجوعُ يمدُّ مخالبه في بطني
فألتهم أوراقي
وأمشي...
واضعاً يدي على بطني
خشية أنْ يَسمع أحدٌ طحينَ الكلمات"
ولكنَّ جوع الشاعر هنا هو جوع نفسيٌّ وحسب، لا علاقة له على وجه الحقيقة بأمعاء بطنه، إنه جوع يمثل الحاجةَ.. الخواءَ.. الطريقَ إلى الانتهاء، ومن هنا يتحول إلى رمزٍ من رموز الشاعر.
ويعبر الشاعر أيضاً عن شعورٍ آخر يُلازمه ويؤرِّقُهُ وهو الندم الذي يبرز بوضوحٍ كواحدٍ من موضوعاته الشعرية التي أراد هنا أن يؤكدها وأن يُوجد لها حيزاً بارزاً من بين مشاعره، ففي قصيدته "أوراق من سيرة تأبط منفى" يقول:
"وهذه الندوب، عضَّاتُ أصابعي
من الندم والغضب والارتجاف
فلا تبحثي عن طالعي في راحتي
-يا سيدتي العرافة-
مادمتُ مرهوناً بهذا الشرقِ
فمستقبلي في راحات الحُكّام"
وفي موضعٍ آخر منها يقول:
"وفي الليل
أخلعُ أصابعي
وأدفنُها تحتَ وسادتي
خشيةَ أنْ أقطعها بأسناني
واحدةً بعدَ واحدةٍ
من الجوعِ
أو الندم
وفي قصيدة أخرى غيرها يقول:
"مْ تعدْ في يدي
أصابعُ للتلويحِ
لكثرة ما عضضتُها من الندم"
إنَّ تردُّد كلمة الندم في شعر الشاعر ليس تردُّداً اعتباطياً، كما لا يجب أنْ يكون، فما هي ضرورتُهُا، وما هي وظيفتُها، وما الذي أرادَه الشاعر من خلالها. هل هو ندمٌ على شيء لم يفعله؟ لا مبرر للندم في هذه الحالة، أم على شيء فَعَلَهُ، أو لجأ إلى فعلهِ مضطراً، وعلى كلٍّ فما الذي فعَلَه الشاعر وسوَّغَ أنْ يندمَ من أجله، ويتمنى لو أنه لم يفعلْهُ؟ إنَّ موضوع الندم هنا يقع في حيَّز الاعتراف غير المقصود الذي يقع في فخّه المبدعون!، حيثُ السماح لحالة اللاوعي أنْ تتصرف بشيء من الحرية، دون أنْ تقف أمامها رقابة المبدع نفسه، بينما تبقى رقابة الناقد يَـقِظةً لتؤدّي مهمتها في التحليل ومنه التحليل النفسي للنصّ.
أما مشاعره المعقدة فمنها الإنفصال في الشخصية-شخصيته، فنراه بشخصيتين متناقضتين، وعندما يُفيقُ من نوبتِهِ ويعود إلى شخصيته الأولى يعترف بمرضه هذا ويضع قصيدته التي كتبتها شخصيته الثانية تحت عنوان اسم المرض: الشيزوفرينيا:
"في وطني
يجمعني الخوفُ ويقسمني:
رَجُلاً يكتبُ
والآخرَ خلفَ ستائرِ نافذتي،
يرقبُـني"
ويصل مرضُ الشاعر هذا إلى أخطر حالاته عندما تعظم الهوَّةُ بين شخصيته الأولى وشخصيته الثانية كما هو الأمر في قصيدته "أبواب":
"أطرقُ باباً
أفتحُهُ
لا أُبصرُ إلاّ نفسي باباً
أفتحُهُ
أدخُلُ
لاشيءَ سوى بابٍ آخر
يا ربي
كمْ باباً يفصلني عنّي؟!"
فكيف إذا تساوتْ الأشياءُ ومتناقضاتها لدى الشاعر:
"إنزلْ أو فاصعدْ
-لافرق-
إيَّانَ تَجوبْ..؟
القمَّةُ بئرٌ مقلوبْ"
الشاعر مريضٌ إذن، ويبدو لي أن مرض عدنان الصائغ من الأمراض المستعصية!، إنه مريض بالإبداع، أفليسَ الإبداع مرضاً؟، وكيف يمكن للمرء أنْ يكون مبدعاً دون أنْ يكون مريضاً؟ والمرض هنا، لحسن حظ المبدعين هو مرض إيجابي، يضر المبدع وينفع الجمهور، فهل يتمنى عدنان الصائغ أنْ يشفَى من هذا المرض فيستريح، أمْ إنه يميلُ إلى كفَّة الجمهور فيشقَى؟!.
ويأخذ الشقاءُ عنده شكلاً آخر أيضاً، بسبب إبداعه، فَيحاول دفعَ هذا الشقاء، والدفاعَ عن مرضه في جملةٍ من قصائد هذه المجموعة، متناسياً أنَّ المريض يثقلُ على الضعفاء (!):
"يلمونني سطوراً
ويبوبونني فصولاً
ثم يفهرسونني
ويطبعونني كاملاً
ويوزعونني على المكتبات
وأنا
لمْ
أتحْ
فمي
بعد"
أرأيتَ كيف عبَّر عدنان عن حرقته الشديدة وألمه الممضّ في أنْ جعلَ كلَّ كلمةٍ من جملته الشعرية الأخيرة في سطر مستقلّ، وكأنه يركِّز لفظَ كل كلمةٍ ويُشدِّدَ عليها ويَضغط على شفتيه بكل قوَّةٍ وهو يلفظها، ثمَّ يستغرقُ في تلفُّظها وقتاً طلباً للتأثير الذي تستحقه القضية؟، ثمَّ إنَّ هذا كلَّه جاء، في الوقت نفسه، متكافئاً مع القدر الذي يريده الشاعر من الإستهزاء لكي يكيلهُ لهؤلاء الذين يُشير إليهم بالضمير. إنه يُفصِّلُ مساحةَ هذه القصيدة بشكلٍ بارعٍ على موضوعها- موضوعه.
وهذا الضمير الذي يُشير به إلى شاتميهِ يتكرر في قصيدته "إليهم فقط..."، التي يرثي لحالهم فيها ويَسِمُهم بالخواء، يتحوَّلُ إلى ضمير مفردٍ في قصيدته "إلى..." ولم يُسمِّ صاحبَهُ، إذْ كان لهُ مِنْ قبلُ صاحباً!. هذه القضية هي أهون قضايا-هموم عدنان الصائغ في شعره وأقلها شأناً، فما هي قضاياه-همومه الأخرى؟.
تتوزع قصائد عدنان الصائغ الأُخرى على قضايا تبدو كلها على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، ويمكننا تقسيمها على اتجاهين رئيسين هما: الوطن والمنفى وما إليهما، وتأملات فلسفية واجتماعية وما إليها. ففي الإتجاه الأول يجد القارئ كوابيسَ ومشانقَ وصراعاتٍ وآلاماً ومشاكل، وفي الثاني يجد أحلاماً وآمالاً وزهوراً وطرائف، فهو يغفو بطريقتين!.
فمن كوابيسه التي تصل إلى غايةٍ بعيدةٍ من الإزعاج والقسوة قصيدته التي يقول في أثنائها:
"لا أعرفُ متى سأسقط على رصيفِ قصائدي
مكوَّماً بطلقةٍ
أو مثقوباً من الجوعِ
أو بِطعنةِ صديقٍ
يمرُّ الحكَّامُ والأحزابُ والعاهراتُ
ولا يد تعتُّ بياقتي وتُنهضني من الركامِ
لا عنقَ يستدير نحوي
ليرى كيفَ يشخبُ دمي كساقيةٍ على الرصيفِ
لا مشيعين يحملونني متأففين إلى المقبرة"
ولعلَّ الشاعر يصلُ بالقصيدة إلى ذروتها من الفنتازيا وبراعة التوصيف لذاتهِ وهو حيٌّ ميِّتٌ في آنٍ حين يقول:
"الأقدامُ تدوسُني أو تعبرني
وتمضي
الفتيات يشحنَ بأنظارهنَّ
وهنَّ يمضغنَ سندويشاتهنَّ ونكاتهنَّ المدرسية البذيئة
ومئذنة الجامع الكبيرِ
تصاعدُ تسابيحها –ليلَ نهار-
دونَ أنْ تلتفتَ لجعيري"
وهو هنا يُحسنُ اختيار مفرداته وترتيبها بما يتناسب ومواقفه، فيقرن كلمة الأحزاب بالعاهرات، وينصُّ على النكات البذيئة في مشهد قتله مذبوحاً ودمه المنشخب على الرصيف، لتعميق الشعور بالمفارقة بين مشهدَيْ الفجيعة واللامبالاة بها، ثم النصُّ على "الجامع الكبير"، فأي دلالةٍ يحملُ هذا الجامع الكبير في هذا الموضع؟، وأخيراً فإنَّ الشاعر استخدم كلمة الجعير لوصف صوته المتألِّم، وهي عاميةٌ تُستخدم للحيوان على الأغلب، وللإنسان في موضع الإستهزاء، لكي يُكملَ بها صورة تلك اللامبالاة في مشهد الفجيعة.
والشاعر في هذه الحالات جميعاً يعبر عن قضية الإستلاب التي يعانيها المواطنون في وطنٍ مثل وطنه هو، ويجعل من نفسه، دون أنْ يدري، صورةً للمواطن مسلوب الإرادة، محكوماً باللارغبة واللاخيار، محاطاً بالقهر والإذلال السلطوي بمستويين: السلطة-المواطن، والمواطن-المواطن، وهذا الأخير هو واحد من نتاج السلطة المحض، كذلك.
ومن ضفتهِ الأخرى يستطيع القارئ أنْ يلتقط من مخيلته كثيراً من الطرائف والمسليات مثل قوله:
"وأنتِ تمرّينَ بخدكِ المشمشي
كمْ من الشفاهِ تلمظتْ بكِ
في الطريقِ إليَّ؟!"
أرأيتَ كيف جاءتْ "المشمشي" هنا؟!، إنها من براعات عدنان الصائغ، وأدعوكَ أيضاً لترى كيف رسمَ بالكلمات هذه اللوحة الجميلة:
"بِإبرتِهِ المائيَّةِ
يَخيطُ المطَرُ
قميصَ الحقول"
وهذا واحد من تأمُّلاته الكثيرة في الحياة والمجتمع، وكثير منها مؤطَّر بفلسفة الشاعر ورؤياه، وكثير منها يشكلُّ ما يمكن أنْ أسمِّـيَهُ "القصيدة اللقطة"، وكلُّها تستحقُ الوقوف والتحليل، كمثل قوله:
"أقدامنا/ أرصفةٌ متحركة"، و"الظلُّ/ شيخوخة الزمان"، و"في الفحم/ نارٌ حبيس"، و"الكلامُ/ ركضٌ داخلي"، و"في بال النمر/ فرائس كثيرةٌ/ خارج قفصهِ/ يقتنصها بلعابه"، و"باستثناء شفتيكِ/ لا أعرفُ/ كيفَ أقطفُ الوردة"، و"ما الذي يعنيني الآن / أيها الرماد/ أنكَ كنتَ جمراً"،
وغير ذلك مما أراد أنْ يثبت من خلاله أنه ينظر إلى الأشياء بأسلوبٍ مغاير، ولكنه أسلوب مشحونٌ بالطرافة، يدعو إلى ترويض الذهن، وإعادة النظر في الأشياء المعتادة.
وهناك قضيةٌ تَستحقُّ التوقف والتأمُّل استجدَّتْ في شعر عدنان الصائغ وهي مناجاة الله، ورفع الكلفة وهو يُخاطبه، بلْ يُحاسبُه، فيرتفع بالمناجاة من الدعاء والتوسُّل إلى التخاطب الحميمي الذي يقرِّبُ بين العبد المؤمن وربه في حالة من حالات التسامي الصوفية، ولكن أين الشاعر من هذه الحالة؟. إنه يُخاطب الله بشفافيةٍ لذيذةٍ فيقول:
"أيها الربُّ
أُفرشْ دفاترَكَ
وسأفرشُ أمعائي
وتعال نتحاسبْ"
ويُسائلُهُ سؤال العارف في قصيدة أخرى، ولكنه سؤال المحتجِّ في الوقت نفسه محاولاً أنْ يوجدَ مبرراً للجدل والاحتجاج، ولكنه لا يفعل شيئاً سوى أنْ يتساءل:
"أيها الربُّ إذا لم تستطعْ أنْ تملأ هذه المعدة الجرباءَ
التي تصفر فيها الريحُ والديدانُ
فلماذا خلقتَ لي هذه الأضراسَ النهمة
وإذا لم تبرعمْ على سريري جسداً أملوداً
فلماذا خلقتَ لي ذراعين من كبريت
وإذا لم تمنحني وطناً آمناً
فلماذا خلقتَ لي هذه الأقدامَ الجوَّابة
وإذا كنتَ ضجراً من شكواي
فلماذا خلقتَ لي هذا الفمَ المندلقَ بالصراخِ
ليلَ نهارْ؟"
ويذهب بالاحتجاج عليه بعيداً فيتساءلُ بشكل غير مباشرٍ هذه المرة عن أشياء يراها من اختصاصه ويراه شديد الحلِْم فيها، فيقع في طائلة التجسيد:
"أُريدُ أنْ أصعد يوماً إلى ملكوته
لأرى
إلى أين تذهبُ غيومُ حشرجاتِنا
وهذه الأرض التي تدور
بمعاركنا وطبولنا وشتائمنا واستغاثاتنا
منذ ملايين السنين
ألمْ تُوقظْهُ من قيلولتهِ الكونيَّةِ
ليطلَّ من شرفتِهِ وينظر لنا
مَنْ يدري
ربما سئمَ مِن شكوانا
فأشاحَ بوجهه الكريمِ ونسينا إلى الأبد"
ويرى الشاعر نفسه مستلطفةً لهذا الموضوع مستجيبةً له كلَّ الاستجابة فيسترسل فيه، ويسترسل في التجسيد والتشخيص:
"مستلقياً على ظهري
أُحدِّقُ في السماء الزرقاء
وأُحصي عددَ الزفرات التي تصعد إلى الله كلَّ يومٍ
وعددَ حبَّات المطر التي تتساقطُ من جفنيهِ
أُديرُ قُرصَ الهاتفِ
وأطلبُهُ
تردُّ سكرتيرته الجميلةُ
إنه مشغولٌ هذه الأيام
إلى أُذنيهِ
بتقليب عرائضكم التي تهرَّأتْ من طولِ تململها في المخازن
يا سيدتي أريدُ رؤيتَهُ ولو لدقيقةٍ واحدةٍ
ما مِن مرةٍ طلبتُهُ
وردَّ عليَّ
أريدُ أنْ أسألَهُ قبلَ أنْ أُودِّعَ حياتي البائسة
وقبلَ أنْ يضعَ فواتيرَهُ الطويلةَ أمامي:
يا إلهي العادل
أمِنْ أجلِ تفاحةٍ واحدةٍ
خسرتُ جِنانَكَ الواسعةَ أَمِنْ أجلِ أنْ يسجدَ لي ملاكٌ واحدٌ
لم يبقَ شيءٌ من التاريخِ إلاَّ وركعتُ أمامَه؟
.....
إذا كنتَ وحدَكَ مالك الغيبِ..
ولمْ تُفشِ أسرارَكَ لأحدٍ
فكيفَ علمَ إبليسُ
بأني سأعيثُ في الأرضِ فساداً
...
وإذا كنتَ حرمتَني
مِن دمِ العنقودِ
فلماذا أبحتَهُ لغيري
...
وإذا كان الأشرارُ لم يصعدوا إلى سفينةِ نوحٍ
وغرقوا في البحرِ
فكيفَ امتلأت الأرضُ بهم ثانيةً؟"
وإذا نحن نستغرب إلغاءَ الشاعر الكُلفةَ إلى هذا الحد بينه وبين الله، فإننا نعلمُ في الوقتِ نفسه أنَّ ذلك مُعادِلٌ لحالة الجَزَعِ التي يمر بها الشاعر، ويبدو أنها لم تغادرْهُ كثيراً حتَّى جعلتْه يستعذب الألَمَ فأخذَ يدورُ في أغلبِ قصائده، وهي حالة يمرُّ بها كلٌّ منّا أحياناً، ولكن الشاعر لا يدعها تُفلتُ دون أنْ يُسجلها، فتُحسَبُ عليه، أو لهُ، لأنها تدور في إطارها الفني، بعد أنْ ينقلها الشاعر من غير المألوف إلى المألوف، وهذا واحد من وظائف الفنّ وأهدافه الجديرة بالاحترام. ونحنُ لا نظنُّ أنه يشهد حالةً من الاتحاد والحلول الذي يعتور المتصوِّفة. وبعد ذلك لا يخلو هذا النمط لديه من الطرافة المُستَعذَبة.
والشاعر عدنان الصائغ، من ناحيةٍ أخرى، لا يعتني بالإيقاع، ولا يأبه بموسيقى الشعر أو التقفية في جميع قصائده، وكأنَّ الإيقاع وعيٌ وحضورٌ، والعمل الشعري إغماء وغياب، فإذا انتابَهُ واحدٌ من كوابيسه جاء النصُّ بلا إيقاع، وتخلَّى عن التقفية في حدِّ من الحدود، أو هكذا يُهيَّأُ لي. وربما أراد الشاعر أنْ يتركَ النصَّ ينسلُّ على سجيتِهِ، فلا يُوقظُ حاسة الفنّ الشعري فيه باستثناء اللغة، كما لا يريد إيقاظ النص من شكله الذي ولد فيه أول مرة خشية الإفتعال من خلال التغيير والتشذيب، فيكون في ذلك سرياليَّ النـزعة في هذا الشأن، وجاء أغلبُ قصائده في هذه المجموعة على هذه الحال، ولو كان غير قادرٍ على ذلك لكان لنا قولٌ آخر، ولكن الصائغ من الشعراء القادرين على نفث روح الإيقاع في شعره، فيضيف إلى متعة الأفكار والتأملات متعةَ الفنّ. أنظرْ إليه وهو يقول:
"عمرٌ..
أو عشرة أعمارْ
لا تكفي
يا ربّي
كي أشبعَ من صحنِ أنوثتها
بدلاً من حُوركَ والأنهارْ
أوليستْ لي حريَّة أنْ أختارْ"
ولاشكَّ في أنكَ تنجذبُ انجذاباً وأنتَ تقراُ هذه القصيدة منذ الجملة الشعرية الأولى إلى موسيقاها وتشعر بعذوبةٍ مصدرُها إيقاعُ بحر المتدارك وقافيةُ الراء الساكنة وهو صوتٌ ترددي مموسَق، فكيفَ إذا صاغَ الصائغُ لك قصيدةً فيها قافيتان تتراوحان ساعَدَتاهُ على اقتناصِ لحظةٍ غنيةٍ من لحظات البوح النفسي والعاطفي، هكذا:
"العراقُ الذي يبتعدْ
كلما اتَّسعتْ في المنافي خُطاهْ
والعراقُ الذي يـتَّـئِدْ
كلما انفتحتْ نصفُ نافذةٍ
قلتُ: آهْ
والعراقُ الذي يرتعدْ
كلما مرَّ ظلٌّ
تخيلتُ فوَّهةً تترصَّدني،
أو مَتاهْ
والعراقُ الذي نَـفتقدْ
نصفُ تاريخهِ أغانٍ وكحلٌ..
ونصفٌ طُغاهْ"
أرأيتَ كم تكونُ القصيدة جميلةً وقريبةً من القلب بالإيقاع وموسيقى الألفاظ أيها الصائغ؟!.
أما بعدُ، فما زال في الكلامِ مُـتَّسَعٌ حول شعر الشاعر عدنان الصائغ الذي تأبَّطَ منفاه، ولعلَّ لذلك مناسبةً أخرى.
(*) نشرت في مجلة "الواح" – مدريد 16 - 2003
|